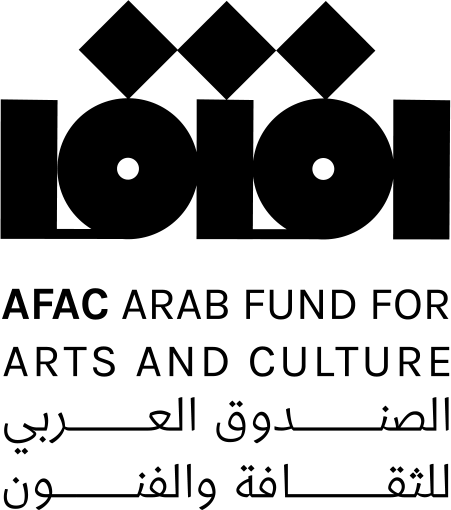نتج عن رحلة بحث المخرجة الفلسطينية الأردنية لينا العبد عن والدها ابراهيم فيلم وثائقي شخصي في عنوان "ابراهيم: إلى أجل غير مسمّى". حصد الفيلم مؤخّراً جائزة لجنة التحكيم في مهرجان قابس سينما فن السينمائي. تكشف العبد من خلال هذه المقابلة تفاصيل من صميم رحلتها.
فيلمك "ابراهيم: إلى أجَلٍ غير مُسمّى" هو رحلة شخصية استكشافية حميمة، متعددة الطبقات، لتتصالحي مع اختفاء والدكِ. هل شعرتِ أنك مع هذه الرحلة وصلتِ إلى هذه المصالحة؟ هل كانت رحلة الفيلم علاجية بالنسبة إليكِ؟ وهل تشعرين أنك شخص مختلف بعد الفيلم؟
عندما بدأت العمل على الفيلم، قادني هاجس فهم ما حدث لوالدي. الفيلم كان بالتالي، في بدايته، فيلماً استقصائياً. مع مرور الوقت (اذ استغرق الفيلم سبع سنوات لينجز)، وبالتحديد بعد سنتين أو ثلاث سنوات من البحث، فهمت أنني لن أستطيع فهم الحقيقة. حقيقة أنّ والدي كان عضواً في منظّمة أبو نضال، إحدى أكثر منظمات العالم سريّة، وكون الأخيرة لا تزال ناشطة الى يومنا هذا رغم تقلّص دورها وقوّتها، جعلا الأمر معقّداً بشكل كبير. في ما يخصّ سؤالك اذا كنت ما زلت نفس الشخص الذي كنته قبل الفيلم: بالتأكيد لا. بالتأكيد كان لكلّ ما حدث في السنوات السبع الماضية تأثير كبير على فهمي لطفولتي وما عانيته من صدمة. كان هناك لحظة حين أدركت أن نتيجة الرحلة ليست بالأمر المهمّ، إنما ما يهم هو الرحلة نفسها. في النهاية، وبعد سبع سنوات وبعد إنجاز الفيلم، كنت راضية كوني استطعت أن أخبر قصتي عوضاً عن أن يرويها عني شخص آخر. بعد كل هذا الوقت، أحسست أنني الآن أدفن ابراهيم. لم يكن هذا سهلاً بالتأكيد، بل قاسٍ الى حدّ كبير، غير أنه لم يكن حزيناً كوني لم أكن وحيدة في هذه الرحلة. رامي نيحاوي كان يرافقني طوال مدّة الرحلة كشريكي الأساسي. كما شاركني الرحلة مهنّد يعقوبي ورولى الناصر. عدد كبير من الأصدقاء عمل معي، بما في ذلك مؤسسات داعمة ساعدتني على تحقيق هدفي. حتّى أن الغرباء الذين قابلتهم خلال رحلتي ورويت لهم قصّتي أبدوا دعمهم.
عنوان الفيلم قائم على سؤال مفتوح. نشعر عند مشاهدته أن "الحقيقة" لا زالت بعيدة المنال وأن الأسئلة التي يطرحها في البداية لا يجيب عنها الا بالمزيد من الأسئلة. أطلعينا على هذه الرحلة.
بعد بضع سنوات من بدء عملية التصوير، وحين أدركت أن الفيلم ليس عن مكان مقتل ابراهيم – لأن الإحتمالات كانت كثيرة، وكلما تعمّقت أكثر بالبحث، كانت تظهر احتمالات أوسع، كما كان واضحاً من إجابات كلّ شخصية من شخصيات الفيلم عندما كنت أسألهم عن مكان ابراهيم – أدركت أنني لن أتمكّن من اكتشاف الحقيقة. في هذه اللحظة، تحوّل بحثي الى سعي شخصي لأفهم الصدمة التي مررت بها ولأدرك معنى "الوطن" وكيف أعرّف نفسي: فلسطينية، سورية، مصرية حاملة لجواز أردني، عشت في بيروت لعشر سنوات أثّرت كثيراً في شخصيتي، وحالياً أعيش في إيطاليا. بهذا المعنى، تحوّل الفيلم إلى مساحة لإعادة التفكير بالأسئلة التي افترضنا أن الوقت قد أجاب عنها. هذه المواجهة، كفرد وكفتاة فقدت والدها، وحتّى كفلسطينية، كانت ضرورية لأتصالح مع نفسي على مستويين: المستوى الشخصي والمستوى التاريخي.
في الفيلم، تتوجّهين الى والدك مباشرة. نشعر بوجوده من خلال كلماتك. نشعر أنّك تستخدمين الكاميرا لاجراء حوار ما معه، ولإعطائه مساحة وجود.
بالضبط. هذا ما أحسسته في بعض الحالات، كما في المشهد مع فريد، صديق ابراهيم من أيام المدرسة في فلسطين والذي يسكن حالياً في عمّان. حين كنت أجري معه المقابلة، كنت أفكّر أن والدي كان بامكانه أن يكون مكانه الآن. دعيني أوضّح أمراً ما: نحن خمسة إخوة في عائلتي. الثلاثة الأكبر سنّاً يذكرونه، بينما أخي الأصغر جهاد وأنا – كنت أبلغ ست سنوات حينها وجهاد كان في الثالثة من عمره – لا نتذكّره، خاصة أنه كان كثير السفر. ما زلت أذكر أمرين عنه مرتبطين بالأحداث التي جرت معه، ولم أكن متأكّدة من أن ما أتذكره حدث بالفعل، أم أن مخيلتي هي من ابتدعته. في سنواتي الأولى، بعد أن كبرت وبدأت أدرك غياب صورة الأب في عائلتنا، بدأت أسأل أصدقائي: ماذا يعني أن يكون لك أب؟ شعرت أنه أمر مختلف عن أن يكون للولد أمّ. بعيداً عن الجينات التي أحملها منه، ما هو شعور أن يكون لي أب؟ كبرت مع صورة بطل لا تفصلني عنه أية حدود، كوني لم أكن أعرفه. الأمر كان مختلفاً جداً مع أخي اياد وأختي نجوى. هذه "الحرية" سمحت لي أن أرى ابراهيم في كلّ شخصية من شخصيات الفيلم. تمكنت أن أرى تأثير غيابه علي وعلى شخصيات الفيلم كافّة.
أمر آخر ملاحظ في الفيلم هو كيف تدخلين المشاهد الى عالمك الخاصّ، من خلال مشاهد من المطبخ، ولقطات حميمة مع أمّك وأختك، ومشاهد الحياكة... كما لو أنكم كعائلة تحاولون، من خلال مسار الفيلم، بناء رواية مشتركة حول هذا الغياب الكبير الذي أثّر فيكم جميعاً وفي خياراتكم في الحياة. أخبرينا المزيد حول تأثير الفيلم وعملية صناعته على الروابط والعلاقات في عائلتك.
لم نعتد كعائلة أن نتكلّم عن هذه القصّة أبداً. حجر الأساس في بناء الفيلم مرتبط مباشرة بمدى قدرتي على تفكيك شخصيتي سيكولوجياً. وأعتقد أن إنجاز الفيلم استهلك وقتاً طويلاً، ليس بسبب البحث عن تمويل مثلاً، بل بسبب حاجتي لاستيعاب الأمور. أعرف أن هذا كان خياري ولم يكن خيار أي من أفراد عائلتي. كانت أمي قلقة في بداية الأمر، وخائفة الى حدّ ما، وكانت دائماً تصفني بـ "المجنونة" لإقدامي على المشروع. وكنت دائماً أجيبها بأنني أحاول أن أبني رابطاً معه. ولكن مع الوقت بدأت تظهر دعماً كبيراً لي وتشجّعني على إنجاز الفيلم. أظن أن كلّ شخصية في الفيلم، وفي كل مرحلة من مراحل صناعته، تأثّرت بطريقة ما.
هذا التأثير أشعرني بالراحة، ولكنّي لا أعرف اذا كان هذا هو الحال مع الباقين. بالنسبة إلى فريد مثلاً- ووالده الذي التقيته خلال البحث والذي رفض الظهور في الفيلم- كان الأمر مختلفاً. لم أكن أسألهم عن ابراهيم فقط، كنت أتحدّث معهم عن المرحلة كاملة، وهي مرحلة قاتمة لا يحبّذ أي فلسطيني التحدّث عنها. هذا أمر يظهر على الصعيد الشخصي. أختي نجوى مثلاً، قاومتني لثلاث سنوات ونصف، رافضة المشاركة في المشروع. لزمني بعض الوقت لأفهم أن تأثير غياب والدي كان مختلفاً على نجوى، فهي كانت في عمر الخامسة عشرة حين اختفى.
أظّن أن مخيلتي كانت إحدى وسائل الدفاع التي أستخدمها. في البداية، وحتى دخولي الجامعة، كنت أستلقي وأقول لنفسي أن أبي موجود وهو يسافر ويجلب لي هذا وذاك... بعد فترة استوعبت أن المخيّلة هي احدى وسائل التعافي من الصدمة لفتاة في عمر الست سنوات.
كان للفيلم تأثير جوهري علينا كعائلة، وكشف أموراً شديدة القبح. كما لو أن جرحاً كان يشفى، وأنت تقومين بخدشه باستمرار. ولكني أعتقد أنّه، ومع مرور الوقت، كان للفيلم أثر مطهّر لنا كعائلة، اذ كنا نحاول بناء قصّة جديدة وأن نكتشف لماذا، خلال كلّ هذه السنوات، لم نكن نتكلّم عنه.
لا بد أن أعترف أن عائلتي لم تأخذني على محمل الجد في البداية. لم يقتنعوا أنني، وبعد كل هذه السنوات، سأكمل بالفعل رحلتي وأنجز الفيلم. لم يستوعبوا أنني سأكمل طريقي مهما كلّفني الأمر وبغضّ النظر عن مشاركتهم. بينما كنت أصوّر في مصر، إلى حيث كانت قد انتقلت أختي حديثاً، وافقت على منحي ثلاثة أيام فقط لأصوّر معها. في هذا المشهد، يمكن المشاهد أن يرى بوضوح أنها كانت المرّة الأولى التي نتكلّم فيها أنا ونجوى عن والدنا. كانت المرّة الأولى التي أسألها عن تأثير غيابه على خياراتها في ما خصّ الرجال.
هذه المواجهة التي جررت العائلة اليها لكي أتمكّن من استكمال رحلتي، كشفت أوجه عدّة من شخصيات عائلتي؛ أوجه قد لا يمكن لنا ادراكها لأننا كنا نعيش حياتنا كناجين وليس كضحايا. هذا هو الإكتشاف الثاني والأهم: لا يجب أن نختبر الصدمات التي نعيشها كضحايا. الخروج من دور الضحية يجعلنا نرى الحياة من منظور مختلف.
إنطلاقاً من قناعتي أن الرحلة هي الأهم، كنت أحاول من خلال عملي على استكمال الفيلم، أن أملأ الفراغ الذي عشته في طفولتي. لكن بعد الإنتهاء من الفيلم، أدركت أنني لن أستطيع ملء هذا الفراغ أبداً. يكمن الإختلاف في طريقة تعاطينا مع هذا الفراغ. حين تروين قصّة صدمتك، أو أبشع أحداث حياتك، تتقلّص حيثيات الحدث، وتتوقّف أن تكون هذا الوحش الذي يلتهم أحشاءك. يضمحلّ الخوف.
ذكرت في عدّة مقابلات، أن انعطافة حدثت خلال تصوير الفيلم حين قمت بزيارة فلسطين. أخبرينا المزيد عن هذه اللحظة المفصلية.
هذه اللحظة المفصلية كانت أساسية. زرت فلسطين في العام 2012، وقابلت 38 فرداً من عائلتي. في دمشق، لم يكن أيٌّ منهم متواجداً معنا. أنا لا أعرف معنى أن يكون لك عمّة. هذه الأيام التسعة التي قضيتها في فلسطين كانت أساسية لتحريري من شعور "اللجوء". من خلال تواجدي في فلسطين، استوعبت مدى انتمائي الى دمشق وارتباطي بها. أنا ولدت وكبرت في دمشق وعشت فيها حتى بلغت الثلاثينات، وتركتها لأنني شعرت بالإختناق. غادرت الى لبنان قبل ستة أشهر من إندلاع الثورة في سوريا.
لحظة عودتي من فلسطين، كانت لحظة انطلاق عملنا أنا ورامي فعلياً على الفيلم. اقتنعت حينها كلياً أنني يجب أن أنجزه. قبل ذلك، كنت أحمل في داخلي شعوراً بالغضب تجاه ابراهيم وتجاه خياره بالسعي لتحرير بلده تاركاً خلفه زوجته وخمسة أطفال، في بلد غريب عنهم. لكنني، ومن خلال تفاصيل عدّة، استوعبت أن هذه كانت أرض. بكلّ بساطة. هذه كانت اللحظة حين أدركت أنني بتّ مستعدّة لفتح هذا الباب لي ولعائلتي، وانطلقنا بمرحلة التحضير. خلال التصوير، كانت فلسطين المرحلة الأخيرة، وكنت آمل، بناءً على أحداث صغيرة حدثت، أن أجد أجوبة، معلومات حسية عن ابراهيم، أو بمعنى آخر، أين توفي ولماذا قتل ومن قتله... وحين انتهيت من التصوير في فلسطين، أدركت أخيراً أن هذا الفراغ لا يمكن ملأه. أدركت أن الأهم هو كيفية التعامل مع القصّة.
في الجزء الأخير من الفيلم، أسأل كلاً من إخوتي وأخواتي ماذا تعني له كلمة "وطن". حين أطرح هذا السؤال على نفسي، أدرك أنها معضلة بالنسبة لي: أين هو "الوطن"؟ ولدت في دمشق وعشت فيها ثلاثين عاماً، ولكن كلّ شيء يشير الى حقيقة أنني لست سوريّة . اليوم أدرك أن "الوطن" هو حيث يقطن من أحبّهم. ففي النهاية، أراهن أنني في لحظة ومكان معينين في كوبنهاغن، يمكن أن أشعر أنني في مكان أود أن أطلق عليه تسمية "وطني". يمكن أن أشعر بنفس الشعور في أحد أحياء تونس. ليس أمراً ملمومساً تستطيعين الإشارة اليه بإصبعك. ربّما لأن حياتي كانت معقّدة جداً، ومفهومي للهوية أكثر تعقيداً.
بالحديث عن كوبنهاغن، العرض العالمي الأول لفيلمك "ابراهيم، الى اجل غير مسمّى" جرى في مهرجان كوبنهاغن للأفلام الوثائقية في العام 2019. كما عرض في مهرجانات تورونتو وأمستردام والجونة حيث فاز بجائزة. كيف كانت الأصداء حول الفيلم؟ كيف تلقّفه الجمهور؟ هل شعرت أن رحلة مشاهدتهم للفيلم مختلفة عن تجربتك؟
في تورونتو، وبعد عرض الفيلم، انتظرني العديد من الحاضرين لالقاء التحية وشكري وكانوا من مناطق مختلفة من العالم. وما أسرني كان شعور أن الناس غالباً يشاركونني هذه القصّة. بالطبع، العديد أتوا ليعترفوا لي أن والدهم، وبالرغم من كونه لم يختفِ ولم يكن ناشطاً سياسياً وليس عربياً حتى، لم يكن متواجداً. بدا الأمر كصفة إنسانية بغض النظر عن الجنسية أو الإثنية. خلال عرض الفيلم في مهرجان تورونتو للسينما الفلسطينية، العديد من العرب من الأجيال الأكبر، والبعض منهم فلسطيني، لم يتقبّلوا فكرّة حديثي عن فلسطين وكيفية معالجتي للقضية. أنا، كفرد، مع المقاومة بالتأكيد، كون الأرض محتلّة. ولكنني أظن أن علينا أن نعيد التفكير بمشاكلنا قبل الحكم على الغير وانتقاد أخطائه. الجمهور في البلدان العربية تفاعل بشكل مختلف، خاصّة مع التفاصيل ومع شخصية أختي وسخرية والدتي. ولكن بشكل عام كانت الأصداء ايجابية الى حدّ كبير.
فاز الفيلم مؤخّراً بجائزة لجنة تحكيم مهرجان قابس سينما فن السينمائي في تونس. ماذا كانت الفكرة الأولى التي خطرت لك، أو ردّة فعلك الأولى وأنت تُكَرَّمين في هذه الأوقات العصيبة؟
أول جائزة أفوز بها خلال الحجر الصحي! بصراحة، علمت أنهم حوّلوا الدورة الى برنامج عروض على الإنترنت، وكنت ممتنّة كثيراً لهذا الجهد. كان من المفترض أن أشارك في سبعة عروض في شهر نيسان/أبريل وكان يفترض أن يحضر رامي اثنين منهم وأن أحضر أنا العروض الخمسة الأخرى. ولكن في النهاية، تدركين أن الأمر ليس شخصياُ، الكوكب كلّه حبيس المنزل. المسألة أكبر من أي شخص، وبالتالي لا تشعرين بالظلم. في البداية، كنت سعيدة جداً بمعنى أنه ما زال بامكاننا الإحتفال بالسينما وبالحياة، رغم أننا – أو على الأقل أنا – نشعر أننا نعيش أحداث فيلم. يجب أن نكون حذرين جداً لتجنّب هذا الإحساس. كنت سعيدة لأن البرنامج ضمّ أفلام أخرى عالية المستوى، وبما أن المنافسة كان تضمّ أفلاماً روائية ووثائقية، لم أكن أتوقّع أن فيلماً وثائقياً سيفوز بالجائزة. أبقيت توقّعاتي بسيطة لتجنّب خيبة الأمل. وفجأة حدث الأمر بالفعل.
في ضوء الوضع الذي نختبره حالياً، وعودة الى شعورك بأنك تعيشين داخل فيلم، هل يحفّز الحجر الحالي أية أفكار جديدة لديك؟ كيف تتعاطين كمخرجة مع هذا الواقع؟
تراودني بالطبع العديد من الأفكار، ولكنني لم أستطع بعد اتخاذ خطوات عملية تجاهها، خاصةّ أننا لا زلنا محتجزين ولا زلنا بحاجة الى استيعاب الوضع. أعتقد أن الكثير من الأمور ستتغيّر. ليس التباعد الإجتماعي فقط – هل سأعود يوماً الى المسرح أو صالة السينما؟ لهذا أنا أخفف من أهمية أية فكرة تردني الآن، وأحاول أن أستوعب الوضع وأتعاطى مع أحاسيسي الآنية.